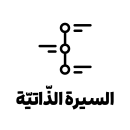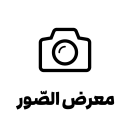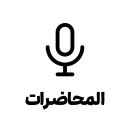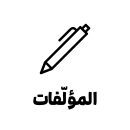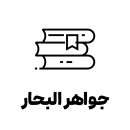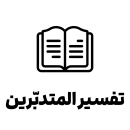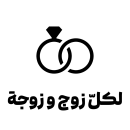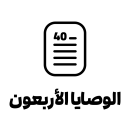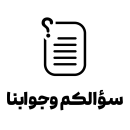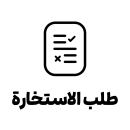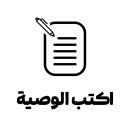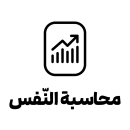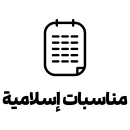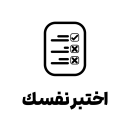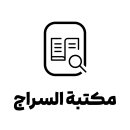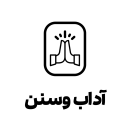شبكة السراج في الطريق إلى الله؛ موقع ثقافي، إعلامي وتبليغي، يهدف لنشر معارف الإسلام المحمّدي وترويج الثّقافة الدّينيّة، يضمّ بساتين من المحتوى الهادف في مختلف المجالات، مضافا إلى محاضرات ومؤلّفات سماحة الشّيخ حبيب الكاظمي.
حكمة اليوم
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: صلّوا على محمّد وآل محمّد، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعائكم له وحفظكم إيّاه (صلى الله عليه وآله وسلم).
هل تريد ثوابًا اليوم؟
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من توضأ وتمندل، كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى تجف وضوؤه، كتبت له ثلاثون حسنة.
الشيخ حبيب الكاظمي
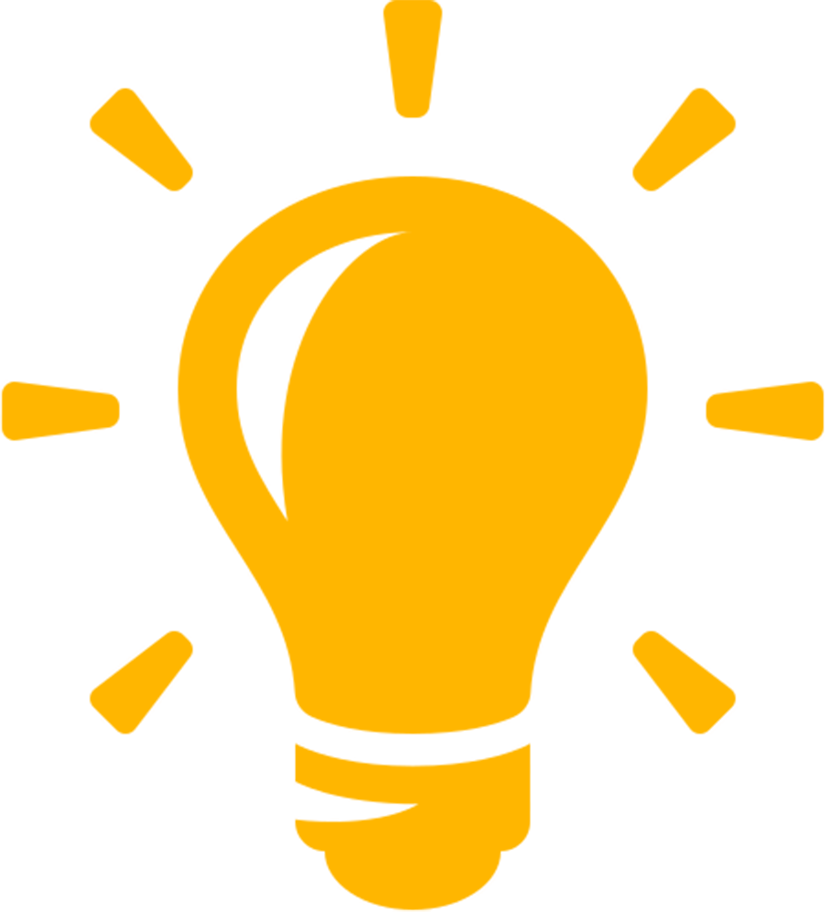
من كل بستان زهرة

مسائل وردود
كنز الفتاوىٰ
بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاثة من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.
إليك هذه الباقة من الفتاوى الفقهية للمرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني التي جمعنا فيها أهم الأحكام الابتلائية، وعملنا على مطابقتها مع مصادرها.